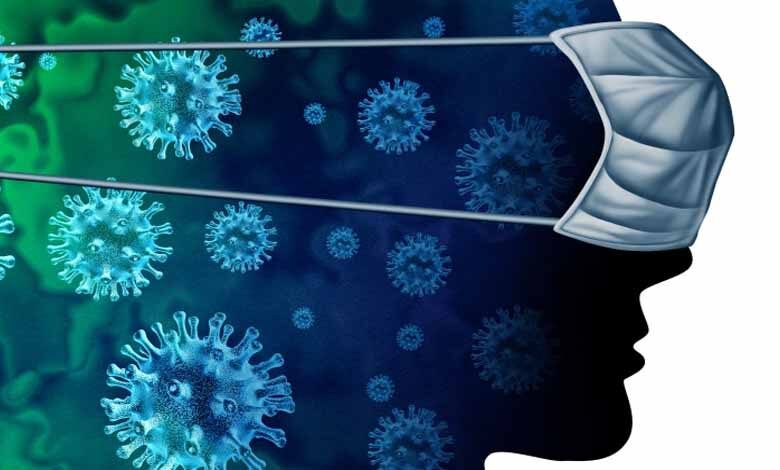
قبل عام لم يكن “حديث الفيروس” شائعا، كان الكلام هامسا ومستبعدا في أحوال كثيرة قصصا عن الخفافيش التي احتضنت البلاء.
وبدأت في إذاعته في “ووهان” الصينية، والتي بدت ساعتها بلادا بعيدة، لم يكن أحد في العالم يعلم أن الدنيا كلها باتت على شفا جرف هائل لا يعرف أحد متى بدأ وبالتأكيد متى ينتهي.
في شهر فبراير من العام الماضي ٢٠٢٠ بات الأمر معلوما، ولكنه ساعتها وسط مشاغل كونية عدة أخذ حجم مشكلة وليس أزمة كبرى لدولة أو أخرى فضلا عن البشرية كلها، ولكن كان ذلك ما حدث تماما فلم تهل شموس وأقمار مارس حتى بات واضحا أن كارثة كبرى تقرع أبواب كل البشر، وبعد أن كانت منظمة الصحة العالمية مصممة على أن الأمر لا يمكن وصفه بالوباء، فإنها لم تأخذ وقتا طويلا لكي تعترف بالحقيقة المرة والتي لم تقتصر على وجود فيروس وإنما أكثر من ذلك أن العلماء والأطباء لا يعرفون عنه الكثير أكثر من أنه من طائفة الإنفلونزا، ولكنه حالة وحدها لا تصيب بالمرض فقط وإنما تقتل.
بدأت الأرقام تبث خوفا ثم رعبا وبعدها جاء الفزع الأكبر، وربما كان تعبير العرب عن الحالة كلها بأنها “جائحة” كانت الأكثر صدقا وقربا من الحقيقة، وتدريجيا مع اقتراب الصيف ذاعت قصص كانت في جانب منها درامية وتراجيدية، وفي جانب ظهرت فيها بطولات لجيش أبيض حدث أنه في خط الدفاع الأول من هجوم مجهول لا يشيع إلا في أفلام الرعب.
وفي هذه الحالة التي ضاقت فيها حجرات العناية المركزة حتى باتت مستعصية على المحتاجين لها، وجد الأطباء أنفسهم يواجهون قرارات للحياة والموت بعد أن باتت أجهزة التنفس شحيحة، فلم يكن أحد يعرف أو كان مستعدا لمواجهة احتياجات لم يحتجها البشر من قبل، وسط ذلك بدا “اللقاح” نوعا من الأحلام والأمنيات، ولكن رد الفعل الإنساني التلقائي كان تعبئة كل الجهود لكي يأتي ما يقف حاجزا أمام الإنسان بين الحياة والموت.
والحقيقة هي أن الأمر كله لم يكن طبيا فقط ولكنه كان اقتصاديا واجتماعيا، وسرعان ما بات سياسيا كذلك حتى دخل ساحة صراعات القوى الكبرى، أكثر من ذلك دخلت مناظرات فلسفية إلى الساحة لكي تعقد المسألة كلها حول أولوية الحياة والاقتصاد، أو هل يفضل الإنسان الموت بالفيروس أم من الجوع؟ وهل تجوز التضحية بكبار السن أم بالأصغر سنا عند الاختيارات على باب غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي؟ لم يكن هناك من مخرج من ذلك كله إلا وجود لقاح أو علاج يدفع الفيروس التاجي بعيدا عن كل الإنسانية، وبينما المؤسسات الصحية والعلاجية تبحث في التطوير والابتكار كان هناك المتعجلون الذين تصوروا الحل في “مناعة القطيع” كما جرى في السويد، وكان هناك الأكثر حكمة الذين وجدوا في التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية والكمامة وسائل لإبطاء عملية انتشار العدوى.
وعلى مدى عام صعب دخلت دول العالم المختلفة في المحاولة، ووجدت ٨١ دولة سبيلا أو آخر بحثا عن اللقاح، وما إن حل الصيف كان ٦٤ لقاحا في دور التجريب، ومع مطلع الخريف كانت ثمانية منها قد دخلت في دور التجارب السريرية، وفي منتصف ديسمبر ظهر أول اللقاحات، وأصبحت بعدها ستة لقاحات متداولة في السوق الدولية.
نظريا كان معنى ذلك أن الأزمة قد انفرجت، وأن ما انتظرته البشرية طويلا قد جاء إليه الفرج، وفي ٢٠ يناير الجاري نشر خمسة من العلماء مقالا في دورية “ستات STAT” وصفوا فيه تحديات تواجه الرئيس جو بايدن فور توليه الرئاسة فيما يتعلق بفيروس “كوفيد-١٩”، وفي الحقيقة فإن هذه التحديات تواجه العالم أجمع، وأولها “قمع الانتشار الحالي” فبعد عام من انتشار الوباء ثبت أنه وصل إلى الدرجة من الانتشار التي تجعل قمعه بالغ الصعوبة، فالدول التي نجحت في أن تصل إلى معدل الإصابة صفر سرعان ما عاد لها الوباء مرة أخرى بعد التخفيف من الإجراءات الاحترازية، وأكثر من ذلك أن الفيروس ذاته بات عرضة لتغييرات كثيرة أو Mutations وهو ما طرح فورا التساؤل حول عما إذا كانت اللقاحات التي جرى إنتاجها، أو التي لا تزال في مرحلة التطوير، تستطيع التعامل مع هذه المتغيرات.
وثانيها فإنه رغم قسوة المرض وما أدى إليه على المستوى الكوني أصاب أربعين مليونا ووفاة مليونين “يوم تنصيب بايدن بلغ عدد الوفيات الأمريكية ٤٠٠ ألف نسمة” وزاد عدد الضحايا في المملكة المتحدة على ١٠٠ ألف، ورغم ذلك فإن فرض إجراءات عزل البشر بالأساليب المشار إليها قبلا بات يحتاج إلى قدرات أكبر لتغيير العقول حتى تتجنب الاختلاط وتلبس الأقنعة، وإذا كان ذلك صعبا في دول متقدمة فكيف يكون الحال في دول أقل تقدما؟
التحدي الثالث هو أن المسألة قد صارت سباقا بين البشر والفيروس، وأن وجود اللقاح وحده لا يكفي لحل المعضلة أو حتى التخفيف منها إلا إذا جرى توزيعه بالسرعة اللازمة للفوز في السباق، وهو ما لا يتيسر إلا بعمليات تعبئة كبيرة للموارد ليس فقط المدنية وإنما العسكرية أيضا لتوزيع اللقاح، مثل هذا الأمر به الكثير من التعقيدات السياسية والقانونية، خاصة أنها تضيف بقوة في كل الأحوال إلى قوة الحكومات المركزية، وأكثر من ذلك فإنها تمثل حاجة ملحة للمزيد من الاعتمادات المالية، وإذا كان ذلك ممكنا في دول غنية ومتقدمة، فإنه يكاد يكون مستحيلا في الدول النامية، هذا التقسيم بين الغنى والفقر في العالم ربما لا يكون جديدا، ولكنه يبدو أكثر إلحاحا بكثير عندما يكون الأمر متعلقا بالحياة والموت في غير زمن الحرب، وحتى في دولة مثل الولايات المتحدة فإن مشروع الرئيس بايدن لتلقيح ١٠٠ مليون أمريكي في ١٠٠ يوم سرعان ما وجد عقبات الزيادة في أسعار معدات الوقاية الشخصية بحوالي ٢٦٠% بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ورغم وجود مراكز للتلقيح فإن اللقاحات لم تكن كافية، وإذا وجدت فإن هناك نقصا في الإمدادات الأخرى ذات الصلة مثل الحقن.
التحدي الرابع له علاقة بالعدالة وضمان الإنصاف ليس فقط بين الدول الغنية والأخرى الفقيرة، ولكن حتى في داخل الدولة الواحدة وبالذات الكبيرة السكان أو واسعة المساحة أو التي تختلف فيها مستويات التقدم اختلافا بينا، وعلى سبيل المثال تمتلئ بوابات الإنترنت لجدولة اللقاحات بسرعة في العديد من المجتمعات، مما يهدد بقطع الأشخاص الذين يفتقرون إلى الإنترنت من دائرة التوصل إلى اللقاح.
إصلاح هذه المشكلات يتطلب وضع معايير للإنصاف وتوفير الموارد والتوجيه للمسؤولين الحكوميين والمحليين حول كيفية تحقيق تلك المعايير، ويقود ذلك بالضرورة إلى تحدٍّ خامس؛ إذ إن الأمر كله يقع في يد الإدارات المحلية للقيام بإجراءات التطعيم ومتابعته وتعزيزه بالجرعات التالية، وهذا في كثير من الأحيان لأنها غير مقتنعة بشرعية القرارات المركزية في هذا الشأن الخاص، وسواء كان ذلك لأسباب سياسية أم دينية.
وفي مثل هذه الأجواء لا يمكن إغفال تحدٍّ سادس لرفع الروح المعنوية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية المنهكين في الأصل بعد شهور طويلة من المعاناة، ولكن هؤلاء ليسوا وحدهم في ساحة مقاومة الفيروس، وإنما -وهذا تحدٍّ سابع- “الجائحة” استحوذت على طاقات الدول على مدى عام كامل تراجع فيه الاهتمام بالأمراض الأخرى، فضلا عن القضايا الملحة في الدول والمجتمعات المختلفة، النتيجة هي أن “كوفيد- ١٩” لن يمضي بسرعة بعيدا عنا.


