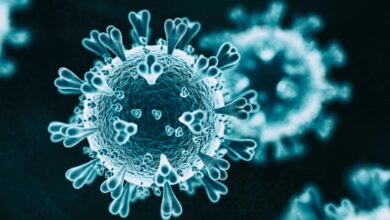هل تملك المملكة المتحدة مقومات”الاستقلال”عن التكتل الأوروبي؟هل كانت قبل وقوع”بريكست” دولة تعتمد كلياً على التكتل الأوروبي في دعم أمنها.
“الاستقلال عن الاتحاد الأوروبي” واحد من أبرز الشعارات التي رفعها البريطانيون خلال رحلة “بريكست”، وهو شعار لا يعبّر عن واقع مضطهد كانت تعيشه المملكة المتحدة تحت راية التكتل، وإنما يعكس رغبة إنجليزية في عزف منفرد قد يجعل البلاد أكثر قوة وتأثيرا وانفتاحا على العالم.
لا تتوفر أدلة كافية على صدق أو كذب هذه النبوءة حتى الآن، ولكن الخروج لا يبدو نهاية غير طبيعية لزواج قلق استمر لعقود بين الطرفين.
حتى قبل دخول طلاق لندن وبروكسل حيز التنفيذ نهاية 2020، شرعت المملكة المتحدة في “استقلالها” عن الاتحاد الأوروبي. فكانت أول دولة تعتمد لقاحاً لكورونا، كما وقعت على اتفاقية تجارة حرة مع كل من اليابان وتركيا، وصنعت لنفسها نظام هجرة جديدا لا استثناء فيه حتى لأشقاء الأمس في القارة العجوز، هذا بالإضافة إلى أنها فعّلت جملة من القوانين لـ”برطنة” شؤونها الداخلية والخارجية اعتباراً من اليوم الأول في 2021.
هل تملك المملكة المتحدة مقومات “الاستقلال” عن التكتل الأوروبي؟ هل كانت قبل وقوع “بريكست” دولة تعتمد كلياً على التكتل الأوروبي في دعم أمنها واقتصادها وعلاقاتها مع العالم؟ هل كانت لندن تتفق مع بروكسل في كل صغيرة وكبيرة إلى حدود التماهي في السياسات الخارجية والداخلية والمالية والاقتصادية؟ هل شكّل طلاقهما صدمة للاقتصاد البريطاني، حتى انهار الجنيه الإسترليني واشتعلت حروب أهلية في البلاد.
الإجابة السريعة لكل هذه الأسئلة تقول باختصار إن المملكة المتحدة قادرة على المضي بمفردها في عالم تحتل فيه المرتبة الخامسة اقتصاديا وعسكرياً، وتستحوذ على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وتشكل قلب الكومنولث الذي يضم نحو مليار وسبعمئة مليون نسمة موزعين على اثنتين وخمسين دولة، كما أن جامعاتها تنافس على المراتب الأولى في العديد من التخصصات العلمية والتقنية والطبية التي تحتاجها الدول لتتقدم.
لا شك أن عضوية الاتحاد الأوروبي كانت سببا رئيسيا في استقرار المكانة التي تنعم بها بريطانيا اليوم عالميا، ولا شك أيضا أن الطلاق الذي وقع بين لندن وبروكسل سينعكس سلبا على هذه المكانة بقدر واضح ولفترة زمنية قد تستمر لعدة سنوات، ولكن يبقى القول الفصل في صمود المملكة المتحدة، وتجاوزها للمرحلة الحرجة بعد “بريكست”، إن جاز التعبير، يتوقف على عدة عوامل داخلية وخارجية لا تقل أهمية أي منها عن الآخر.
أول العوامل الضامنة لسلامة المملكة المتحدة بعد مغادرتها للاتحاد الأوروبي، هو وحدة دولها الأربع المتمثلة في بريطانيا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. فهذه الوحدة هي التي تجعل المملكة عصية على الانكسار، ومؤهلة لاحتواء تداعيات الخروج بسرعة. أما إذا تفككت المملكة، أو خسرت أيا من دولها، فإنها ستصبح عرضة لتجاذبات سياسية واقتصادية داخلية لا تُحمد عقباها، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها على المدى الطويل.
وفق المعطيات المتوفرة إلى الآن، تشكل اسكتلندا الخاصرة الضعيفة للمملكة المتحدة في خطر الانقسام. فالحزب القومي الاسكتلندي يدفع باتجاه طلاق لندن وأدنبرة، ويحشد في سبيل هذا الهدف حتى من قبل سريان “بريكست”. يريد الحزب استفتاءً جديداً على استقلال الاسكتلنديين، متذرعا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شكل ضربة قاصمة لهم، ولا سبيل لتداركها إلا بالانفصال والعودة إلى الأسرة الأوروبية بأقصى سرعة.
القانون يتيح لاسكتلندا إجراء استفتاء واحدٍ على الاستقلال كل عشر سنوات، واستفتاء عام 2014 انتهى بفشل الحزب القومي في مسعاه. صحيح أن المعطيات تغيرت كثيرا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ولكن الحزب لا يمتلك أدلة كافية على جدوى الانفصال مقارنة بالبقاء تحت راية المملكة المتحدة، كما أن برلمان لندن يمكن ألا يوافق على استفتاء جديد شمال المملكة قبل موعده عام 2024 مهما استدعى الحزب الاسكتلندي من أسباب.
رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، والمنتمية للحزب القومي، بشرت بروكسل بعودة قريبة إلى الأسرة الأوروبية، ولا شك أن الاختبار الأول لرغبة الاسكتلنديين في الانفصال عن بريطانيا العظمى بعد “بريكست”، سيكون في انتخابات برلمان أدنبرة خلال مايو/أيار 2021. إن ظفر حزب ستيرجن بأكثرية غير مألوفة، فهذا مؤشر على تيار قوي للطلاق مع لندن، أما إن كانت أكثريته في حدودها التقليدية أو كما هي عليه اليوم، واحد وستون مقعداً من أصل مئة وتسعة وعشرين، فهذا يقول إن أي معركة مقبلة على الانفصال ستكون أكثر شراسة بكثير من الاستفتاء الشعبي الذي جرى في اسكتلندا خلال 2014.
العامل الحاسم الثاني في صمود بريطانيا “المستقلة” أوروبيا، هو امتلاك حكومة حزب المحافظين لاستراتيجية واضحة بشأن احتواء تداعيات الخروج ودعم جميع القطاعات التي تضررت به. وهذا لا يعني فقط تمويل مشاريع أو تنشيط مجالات كانت لوقت طويل تعتمد على التكتل الأوروبي، وإنما يعني أيضا رفد قطاعات الإنتاج بالكوادر الكافية والمتخصصة للنهوض بعمل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والطبية وغيرها.
توفير ما تحتاجه البلاد من يد عاملة وتمويل ودعم لوجستي وفني وتقني، من أجل الحفاظ على تنافسيتها في كافة المجالات، إنما يتطلب انفتاحا كبيرا على العالم. هذا الانفتاح يمثل العامل الثالث في نجاح المملكة المتحدة بتجاوز تداعيات الخروج، ومن دونه يصعب عليها الحفاظ على إنجازات عقود من العضوية الأوروبية التي وفرت الأسواق لمنتجاتها، ورفدت مصانعها وشركاتها ومؤسساتها الطبية والتعليمية بالاحتياجات البشرية المطلوبة.
ولا نذيع سراً بالقول إن المملكة المتحدة تعول في انفتاحها المرتقب على حلفاء استراتيجيين مثل الولايات المتحدة، ودول كبرى في مجموعة الكومنولث مثل الهند وكندا ونيوزيلندا وأستراليا. هذا بالإضافة إلى أنها ستحرص على التعاون الوثيق مع دول غنية مثل مجلس التعاون الخليجي، واكتشاف شركاء تجاريين جدد في قارات العالم المختلفة، خاصة في القارة الأفريقية التي تمتلك المملكة إرثا تاريخيا كبيرا في العلاقة مع بعض دولها.
ربما يسهّل اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، على بريطانيا فتح أبواب جديدة مع العالم. لكنه لن يكون الشرط اللازم والكافي لضمان تجنبها تداعيات “بريكست”، خاصة في المجالات غير الاقتصادية.
هناك كثير من العمل الذي تحتاجه حكومة لندن مع الداخل والخارج لإثبات أنها تستحق “استقلالها” الأوروبي الذي نشدته في الخروج، وكما يقول العالم والفيلسوف الأمريكي روجر فريتس “الفرق بين الواقع والحلم هو العمل”.